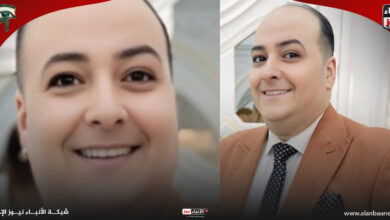الدكتور ظريف حسين يٌكتب لـ الأنباء نيوز : ولماذا نموت؟

قيل إننا لا نستطيع النظر في شيئين: الشمس و الموت.و هذا يعني أننا عاجزون عن مواجهة الموت بقدراتنا الخاصة، فضلاً عن خشيتنا القصوي من تصور فنائنا الشخصي، بما جعل البعض يتصور الموت شيئا غير حقيقي، و بالتالي لا يستوجب الخوف،في حين يعتبره البعض الآخر حقيقياً.
و لكنه ليس بالأمر المرعب. و من المؤكد أن الوعي بالموت مسألة خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات التي يمكنها أن تدرك بدرجة أقل معني الموت، و ذلك لأن وظيفته في الإنسان تكافئ وظيفة الحياة نفسها، بعكس الأمر في الكائنات الدنيا. و من الوظائف المقترحة للموت أنه طريقة لتحقيق العدالة في عالم مختلف ،لأن عالمنا لا يحاكم النوايا و ذات الصدور،و لكن العدالة الوضعية لا تري أهمية لمحاكمة النوازع الشريرة ما دامت لم تترجم إلي أفعال،و هذا ما تعتبره الأديان أصل الشر. كما يعتبر الموت أصلا لكل أفعال الحياة، فلولاه لتقاعس الناس عن القيام بأي نشاط استنادا إلي عدم جدوى ذلك ما داموا خالدين، و لن تكون هناك قيمة للوقت و لا لتاريخ يسجل أفعالهم، و لن تكون هناك أديان ؛ باعتبار الموت أصل الدين فلولاه كان الإنسان خالدا،و الخالد ليس في حاجة لإله .كما لن يكون هناك علم نتغلب به علي الأمراض التي هي رسل الموت، و لا علي بعضنا لأننا محصنون ضد الموت، و لا علي الطبيعة؛ فمهما كانت قوتها فلن تمنع عنا الحياة.
و لولا الموت أيضا ما كانت الثقافة التي نشكل بها معارفنا عن أنفسنا و عن عالمنا محاولين الوصول إلي معني مقنع لوجودنا علي هذه الأرض…و قل مثل ذلك علي الفن،و الأخلاق و القانون ، بل و علي كل عمل إنساني مهما كان. و قد يقال إن الله خلق الموت ليبرهن علي أنه هو الخالد الأوحد.و مهما يكن من تفسير فإن الدين هو المجال الوحيد الذي يقبل كل تفسير و تأويل، و هذه هي خطورة اللعب به و عليه.
و من الناحية الثقافية نجد أن الشعوب الشرقية تقدس الموت، في حين يعتنق الغربيون ثقافة الحياة،و لذلك كان الدين– تاريخيا – منحدرا عن عبادة الأسلاف الصالحين، في حين كان الدين الغربي عبادة لقوي الطبيعة و الحياة، علي اعتبار أنهم يعتقدون (غالبا) بأن الموت جزء من الحياة و بالتالي مكمل لها، بعكس الشرقيين الذين يرونه – في الغالب – نهاية لكل شر و بداية للخير. و للخلاص من الموت فقد تفنن البشر في إيجاد آليات أشهرها: 1 – الطب الغربي الذي يعتبر في جزء منه أن الموت مجرد مرض عارض سوف يتم قهره لاحقا مع تطور العلم. 2 – نفسيا بما يعرف بالفناء الصوفي للأشخاص في الله الأبدي، و ما دام الله أبديا فإنهم أبديون لا محالة، و بذلك لا يعنيهم الموت و لا به ينشغلون. 3-الخلود الاعتباري بالإنجاب و كثرة النسل و انتشاره، ظنا منهم بأن الخلف تمثيل للسلف. 4 – الخلود المعنوي، بالأعمال التي تبقي علي الزمن و تطيل أمد الذكري. 5 – الاعتقاد بتناسخ الأرواح، فالنفوس خالدة في النعيم أو الجحيم بتقمصها أجسادا أخري تكون وسائل لنعيمها أو لجحيمها. و لو حللنا مضمون كلام البشر عن الموت لوجدناه مجرد حادث حياتي معتاد فيما يخص موت غيرهم، و لكن الأمر يختلف تماما في حالة موت أعزائهم ، أو لمجرد التفكير في موتهم هم أنفسهم. و السؤال المهم هو: لماذا نعيش و نقبل علي الحياة – و نموت من أجلها – برغم اليقين بأننا ميتون لا محالة ؟ و لماذا يقتل بعضنا بعضا إذا كنا نتمني الخلود لأنفسنا؟ و بصفة عامة، فإن البشر ليقينهم بالموت تحولوا عن السؤال: لماذا نموت؟ إلي السؤال: كيف نموت؟ و هذا التحول يدل علي واقعية و عقلانية البشر عموما برغم الجنون الذي يكتنف بعضهم. فأما الإجابة عن سؤال لماذا نعيش، فهي أن الحياة نفسها ممثلة في الدماغ تفرز موادا كيميائية تسمي الأندرومورفينات من شأنها أن تشعرنا بالسعادة بل و بالسخرية من الموت نفسه، و بالشجاعة في مجابهته.و لكن هذه المواد لا تعطي مجانا، بل يفرزها المخ حال قيامنا بأعمال الخير و المحبة و التضامن و التسامح و صلة الأرحام، و كفالة اليتيم و الأرامل و تحري الصدق و الأمانة و العدل…و بالإختصار: عندما نفعل الخيرات.كما تفرز أيضا في حالات الترقي و الحصول علي مكافآت أو مناصب…أي في كل حالات تحقيق الذات، و تجسيد معني الحياة نفسها. و معني ذلك أن الحياة لا تعطي نفسها إلا لمن يعطيها نفسه ( أولا ) و بكل إخلاص .فبهذه الأفعال الخيرية فقط يمكننا قهر الموت المتربص بنا من داخلنا . و الآن ماذا عن كراهية الموت لأنفسنا و تمنيه لغيرنا؟ لماذا نقدس حياتنا نحن، و نجلب الموت لغيرنا؟ و الإجابة هي الضلال أو الجهل بالأسباب الحقيقية و العلمية السابقة لمعني الحياة و السعادة فيها، مثلما هو حال المرضي العقليين الموتورين، وكل أعداء الحياة من المتطرفين ، الذين يضحون بالحياة من أجل الموت و بالخير من أجل الشر.فإذا كان الموت الطبيعي حتما مقضيا حتي الآن،فإن علينا أن نتعلم فن الموت بطريقة ترضي ضمائرنا، و تخلصنا من الشقاء الأبدي، بأن نقدس الحياة بتحقيق أحلامنا ثانيا، و بحقن دمائنا أولا !